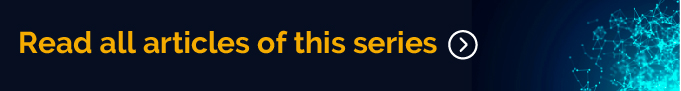إذا كان أواخر القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين، مرحلة انصب فيها الاهتمام على المكان، فأعتقد أن الزمن سوف يكون المتغير الأكثر هيمنة على ما تبقى من هذا القرن، سواء من حيث حقوق الإنسان، أم من حيث مجالات الممارسة والفكر الأخرى.
كانت العولمة ظاهرة مكانية من حيث التعريف: توسع وتمدد الأسواق عبر العالم، واتصال مختلف أركان الأرض عبر شبكات الاتصالات، وصعود النيوليبرالية العابر للحدود. ورغم أن حركة حقوق الإنسان كانت من مصادر تكييل الانتقاد وتكريس المقاومة لأوجه انعدام المساواة التي تسببت فيها العولمة، فقد ظلّت الحركة أكثر تركيزاً على المكان مقارنة بالتركيز على الزمن. لقد ركزت الحركة على تعميم ونشر معايير حقوق الإنسان على مستوى العالم، متجسدة في المعاهدات والاتفاقيات، التي أصبحت جزءاً من لغة الحوكمة العالمية، وفي القلب مما يعتبر من بديهيات الحوكمة العالمية. ومع الانشغال البالغ بتجاوز الحدود المكانية، فقد قمنا نحن – محللو ونشطاء حقوق الإنسان – بتنحية القلق إزاء الزمن، وكأن العولمة كانت "نهاية التاريخ" التي أعلنها فوكوياما.
ها نحن اليوم نعرف أن ذلك كان تشخيصاً متعجلاً، ليس فقط لأن القومية شيدت جدران الكراهية في شتى أنحاء العالم، إنما أيضاً لأن تجاهلنا للزمن ولامبالاتنا به بدأ يعود علينا بالآثار السلبية. إذا كانت هناك أدلة أكثر مطلوبة على أن التاريخ لم ينته بانتصار الليبرالية وحقوق الإنسان، فإن نتائج الانتخابات الأخيرة التي رسّخت نظماً ديمقراطية "لا-ليبرالية" من الهند إلى البرازيل لهي دليل كافٍ.
ولقد مرّت أيضاً مرحلة التكيف والتعامل مع الأزمة المناخية بالتدابير الاعتيادية. كان جيلي (الجيل ×) نتاجاً للعولمة، ولقد ضيّع 30 عاماً كنا بحاجة ماسة إليها لنتخذ فيها خطوات تدريجية ضد الاحترار العالمي. اليوم، يخرج المراهقون من الجيل (Z) في إضرابات عن المدارس ليذكرونا بما توصل إليه العلماء من اللجنة الحكومية الأممية المعنية بالتغير المناخي من نتائج: لتجنب السيناريوهات الأكثر كارثية للتغير المناخي وما سيترتب عليها من أزمات تنال من حقوق الإنسان، فلابد من فرض تدابير عاجلة لخفض الانبعاثات الكربونية إلى النصف بحلول عام 2013 على أبعد تقدير، وهذا هو السبيل الوحيد للخروج من الكارثة.
استرداد التركيز على الزمن يعني أيضاً تغيير طريقة تفكيرنا فيه. عندما كانت العولمة في لحظة ازدهارها وتوسعها، كانت الحقول المعرفية السائدة، من الجغرافيا إلى الاقتصاد السياسي والقانون الدولي، تُركز على المكان لا الزمن. اليوم، من الضروري أن نتعلم من مجالات معرفية أخرى أن تحسن فهمنا للزمن، مثل البيولوجيا والجيولوجيا، بما أن مثل هذه الحقول المعرفية هي الأوثق ارتباطاً بالظواهر الزمانية من قبيل تطور الأنواع وتكوين المناخ.
كما قالت عالمة الجيولوجيا مارسيابيورنرود مؤخراً: "الوعي الحاد بكيف يتكون العالم - وهو يتكون قطعاً بفعل الزمن "، هو وعي مطلوب. هذا التصور يعني إحداث تغييرات لدينا إزاء الأفكار والمقترحات "بشكل يراعي الزمن"، كما أوضحت بيورنرود بكل وضوح.
إنني أقترح مثالين على أفكار "تراعي الزمن" متصلة بحقوق الإنسان. المثال الأول هو الإقرار بحقوق أجيال المستقبل. كما كتب جورج مونبيوت، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان قاصراً، إذ أورد أن "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق". فالإعلان لا يراعي إلا أجيال الحاضر، لكن مواده لا تمنعهم من ترك الكوكب غير قابل للحياة للأجيال المقبلة. هناك مادة مفقودة من القانون الدولي، يجب أن تنص على أن: "لكل جيل حق متساو في التمتع بالموارد الطبيعية"، كما اقترح مونبيوت.
هناك مقترح آخر لمراعاة الزمن، يخص إعلان الطوارئ الدستورية للتصدي للأزمة المناخية وانتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بتلك الأزمة، بالضبط كما يتم إعلان حالات الطوارئ للسماح بتمرير تدابير استثنائية أثناء الأزمات الاقتصادية أو الحروب. إننا اليوم نعرف أننا إذا لم نواجه التغير المناخي بنفس درجة التركيز واتساع النطاق المطلوبين للتعامل مع حرب عالمية، فسوف يؤدي الاحترار العالمي إلى انهيار اقتصادي أسوأ بكثير من الكساد الكبير في عام 1929، مع موت أشخاص أكثر بكثير ممن ماتوا في الحربين العالميتين معاً.
لهذا السبب، أعلنت كل من إنكلترا وأيرلندا طوارئ دستورية لمواجهة آثار التغير المناخي والفقدان الموسع والهائل للأصناف الحيوانية والنباتية. على الدول الأخرى أن تفعل المثل لنفس هذه الأسباب بالضبط.
هذه هي الأفكار التي تدعمها الحركات الاجتماعية التي لديها وعي حاد بالزمن: موجة إضرابات الطلاب لحقوق أجيال المستقبل، وسلسلة المسيرات بقيادة منظمات مثل "ثورة الانقراض" احتجاجاً على اللامبالاة في مواجهة التغير المناخي. وفي حين تذكرنا تحركات الطلاب بأهمية التفكير على المدى البعيد، فإن مسيرات ثورة الانقراض تذكرنا بضرورة التحرك على المدى القصير.
على حركة حقوق الإنسان أن تتعلم من هذه الحركات الأخرى. لذا، فعليها أن تقوم بتحديد أهدافها طويلة الأجل وقدرتها على التعامل على المدى القصير. فيما يخص الأهداف طويلة الأجل، فالتفكير في التوجهات طويلة الأجل هو من نقاط ضعف الفاعلين بمجال حقوق الإنسان، مثل منظمات المجتمع المدني والمانحين الخيريين. إننا لا نفكر عادة بما يتجاوز التخطيط لفترات بين عام وثلاثة أعوام، بحسب دورات التخطيط والتمويل، وكثيراً ما نخفق في توقع التغيرات الجذرية التي تتطلب التحضير "الآن"، وإن كانت ستحدث بعد فترة تتراوح من عشر سنوات إلى عشرين سنة. هناك مثال على ذلك، هو التغيرات العميقة في مفاهيم وممارسات حقوق الإنسان التي ستحدث نتيجة للتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وهندسة الجينات.
وفي الوقت نفسه، فإن الفاعلين بمجال حقوق الإنسان يكافحون لبلوغ عتبة التحرك المنشودة على المدى القصير. إن منظمات حقوق الإنسان يُرجح أن تكون ردودها وتعاملاتها بطيئة وضعيفة في مواجهة التحديات الوجودية، مثل انتشار الشعبوية السلطوية في العالم أو التغير المناخي، وربما كان هذا بسبب الاستراتيجيات التقليدية التي تعتمدها. على سبيل المثال، فإن تحديد والتنديد بالدول التي تنتهك حقوق الإنسان هي استراتيجيات لم تعد مجدية بقدر جدواها سابقاً في عالم من الزعماء الشعبويين الذين لا يستحون. كما لم تعد مجدية في عالم سريع الوتيرة حيث لا تأتي بعض أسوأ التهديدات لحقوق الإنسان من الدول، إنما من شركات القطاع الخاص، التي يمكن لمنصاتها الاجتماعية أن تساعد في زلزلة العمليات الانتخابية في ظرف أيام.
إذا كانت حركة حقوق الإنسان تأمل في أن يكون لها مستقبل، فإن عليها أن تتعامل مع الزمن بكل جدية.